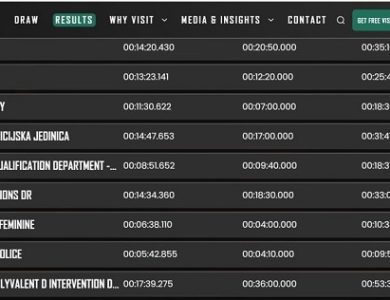فيلم “200 متر”.. الواقع الفلسطيني في مواجهة جدار الفصل العنصري

يرفض بطل الشريط السينمائي الطويل مصطفى القاطن في الضفة الغربية الحصول على الهوية الإسرائيلية باعتباره من عرب 48، ليتحمل بالمقابل أعباء رحلة شاقة وطويلة شبه يومية نحو الحاجز الحدودي الإسرائيلي حيث تقطن زوجته وأبناؤه على الجانب الآخر رغم أن المسافة بين الزوجين لا تتجاوز 200 متر. قصة حقيقية تحاكي حياة الكاتب والمخرج الفلسطيني الشاب أمين نايفة حيث اختار في فيلمه “200 متر” تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين مع جدار الفصل العنصري انطلاقا من تجربة مريرة عاشها خلال طفولته ولا تزال أوجاعها محفورة في ذاكرته.
حقيقة الحياة المأساوية على أرض فلسطين المحتلة

تقع سينما فلسطين بالنسبة إلى الجمهور الخارجي موقع المُكاشفة، الرؤية بنصف عين والحكم بنصف معرفة، بغضّ النظر عن الانتقادات التي تصف مخرجي الموجة الفلسطينية الجديدة بالرخاوة والبقاء في المنطقة الآمنة، إلا أن فيلم “200 متر” طوّر سرديةً تبتعد عن النمط السائد في الأفلام الأخرى، من خلال تركيزه على ملامسة الواقع الفلسطيني وتشريح حياة الأفراد بواقعية ساهمت في رصد وقائعه وحوادثه بصيغة معنيّة بحقوق المواطن الفردية في الحياة كإنسان طبيعي.
تتسرّب المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني عبر تلاشي الأحلام المؤقتة مع انقضاء اليوم وتتجدد بمواصلته، ويتبدّى الضيق المعيشي للفرد في محاولاته التي لا تنتهي من أجل تفكيك الحصار الاقتصادي والمعرفي قبل السياسي، وإرادته في تحقيق أكبر قدر من الأهداف اليومية قصيرة المدى التي تتقاطع بشكل يومي مع المكان كحائط يقف بين الفرد وهدفه.
تنطلق وجهة الفيلم من كونه فيلمًا مكانيًّا من الدرجة الأولى، بدايةً من العنوان الذي يطرح نفسه كمسافة مادّية يمكن قياسها، فالاسم وحده يولِّد صورًا، ويرسِّخ للغة بصرية تصبح في بعض الأحيان مفتاحًا لفهم منهجية الفيلم. ويهيّئ للمُشاهد أن يقرن تلك القيمة القياسية الضئيلة من المكان إذا تمّت مقارنتها ببلدٍ كامل أو حتى حيّ صغير بصعوبة الوصول.
صراع الهويات: عرب 48

“200 متر” يمكن أن تكون المسافة التي تفصل المشاهد عن أقرب بقّال، لكن الأمور تختلف داخل الجانب الفلسطيني، فقياسات المكان بالنسبة إليهم لا يمكن تقديرها بوحدات قياس مكانية، بل بوحدات زمانية، أي يوم أو يومين. ففي فلسطين المحتلة، المكان يتخلّى عن كونه مساحة واسعة من الأرض يمكن اجتيازها بالمشي على الأقدام، ويستحيل خوض رحلة طويلة يمكن أن تستغرق أيامًا، لأن الفلسطيني ببساطة يفتقد لما يُسمّى العبور للجهة الأخرى، فكل الأبواب مغلقة أمامه، ووسائل العبور شرطية وتتقيد بأوقات معيّنة.
لذلك تتحرك فرضية الفيلم لتؤسس إشكالية الاحتجاز التي تناولتها السينما الفلسطينية بشكل متكرر في الموجة الجديدة، خصوصًا المخرج العظيم ميشيل خليفي، إشكالية قمعيّة يتعاطى معها المواطن الفلسطيني بشكل يومي. الفيلم من بطولة الممثل الفلسطيني علي سليمان الذي جسد شخصية “مصطفى” البطل الرئيسي، فيما جسدت الممثلة الفلسطينية لنا زريق دور زوجته سلوى التي تعيش بدورها صراعا داخليا بين حبها لزوجها وتحميله مسؤولية الشتات بسبب رفضه القاطع الحصول على الهوية الإسرائيلية وهو من “عرب 48”.
تقول سلوى في حوار متشنج مع زوجها في أحد مشاهد الفيلم “الحق عليك إنت لأنو كان عندك فرصة إنك تطلّع هوية إسرائيلية لكنك رفضت”، ليجيبها بكل غضب “ما بديش الهوية”.
بأسلوب فني مبهر ومعالجة درامية بسيطة يتحول مخرج الفيلم عبر شخصياته من حالة نفسية إلى أخرى تجعل المشاهد ينجذب لأبطاله ويتعاطف معهم ويعيش آلامهم وانتكاساتهم، فما يعيشه أي مواطن في بلد آخر من تنقل بين بلدة وأخرى هو مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأي فلسطيني يحاول أن يعبر الحدود بين قريتين يفصلهما جدار إسمنتي. اختار نايفة بالمقابل أن يشير بشكل عابر إلى ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن” من خلال مشاهد مقتضبة في الفيلم ترصد صورة عملاقة في شوارع إسرائيل تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محتفيْين بذلك الاتفاق.
سبع سنوات من العمل

لم يغفل مخرج الفيلم عن الخوض في ملف شبكة تهريب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الكيان الاسرائيلي، والصعوبات التي يواجهونها لكسب رزقهم حتى خلال دخولهم بطريقة نظامية عن طريق اجتياز الحاجز الحدودي.
فقد استغرق تحضير الفيلم سبع سنوات من العمل ليتحول من فكرة خامرت صوت وصورة وثق خلالها المخرج معاناته الشخصية ومأساة عائلته التي تشتتت بسبب جدار الفصل العنصري ولا تزال. فوالدته لا تزال تقطن في قرية عرعرة بالجهة الإسرائيلية، فيما يعيش هو في قرية طولكرم بالضفة الغربية، ليكون مجبرا كغيره من أبناء بلده على تحمل مشقة الانتظار في المعبر الحدودي الإسرائيلي. ويروي نايفة بكل حرقة كيف توفيت جدته التي حرم من رؤيتها بسبب الجدار، وكيف تلقى الخبر الصادم عندما كان في طابور الانتظار على الحاجز الحدودي.
حاول المخرج أمين نايفة تأطير العموميات، والتعبير عن معاناة جمعيّة للشعب الفلسطيني في أقصوصة فردية. وقع اختياره على الجدار ليمثّل عقبته الممتدة التي لا سبيل لهزيمتها ظاهريًّا، كحاجز رادع للأشخاص والأحلام وحتى المشاعر، وتطويع ذلك المخلوق الإسمنتي الوغد في فيلم امتدَّ ليتحوّر ويتحول إلى فيلم طريق (Road Movie)، ويكتسب ديناميكية وحيوية أكثر سواء في تقاطعه مع شخصيات عارضة على طول الطريق، أو محاولاته في تجاوز ذلك المأزق الذي يمتدُّ لمئات الكيلومترات.
اقتصرَ وجود جنود الاحتلال داخل الفيلم على عدة مشاهد ضئيلة، ظهروا كأشياء عارضة، بَيدَ أنهم حاضرون من دون وجودهم، يتمثّلون في ذلك الجدار الرادع، الذي يلوح ضخمًا على امتداده المترامي، لا يمكن النفاذ منه، لذلك هو عنصر وجود الجانب المحتل في كل مكان، أشبه بمراقب له عيون في كل مكان، لا يمكن رؤيتها بَيدَ أن وجودها يحمل في داخله ازدراء واحتقارًا لا نهائيًّا من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الازدراء لا يمكن تصويره في إشكالية أخرى أكثر من إشكالية جدار الفصل.
الشعور بالأمل الذي تعطيه قصة الفيلم، هو أمل سقوط الجدار الفاصل الذي أقامته قوات الاحتلال الغاصبة. هذا الجدار سيسقط حتما فهو لم يُكمل 50 عامًا، لأنه قائم على ظلم والظلم لن يُعمر مهما طال الوقت.